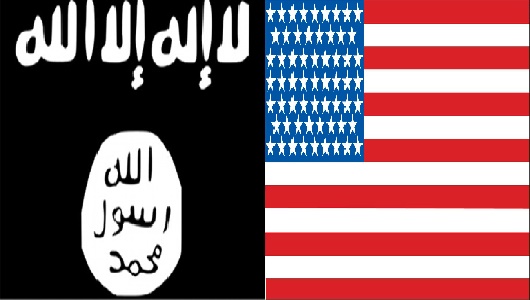
في 2015/10/12
عبد الإله بلقزيز- الخليج الاماراتية-
يومًا بعد يوم، يُثْبت التحالف الغربي- بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية - فشلَه الذريع في ما سماه الحرب ضدّ «داعش». وتسمية الذي يجري بالحرب تسمية غير مطابِقة، فهي لا تعدو أن تكون ضربات جويّة موسمية وانتقامية: تشتدّ حينما يشتبك مقاتلو «داعش» بالبيشمركة في العراق، أو حين يقتربون من مناطق انتشارهم وسيطرتهم، وتخفت - بل تتوقف - حين يندفعون في عمق الأراضي السورية والعراقية للاستيلاء على مزيدٍ من المدن والبلدات والقرى! ليس للأمريكيين والغربيين،حتى الآن، سياسة حقيقية لمحاربة الإرهاب في سوريا والعراق، وذلك لسببين، على الأقل، يفضحان محدودية هذه الحملة العسكرية وانتقائيتها.
أوّلُ ذينك السببين أنّ أيّ حملة من الضربات الجوية- حتى وإن اشتدّت وتكثفت- لن تفضيَ إلى إنهاء قوةِ تنظيمٍ مسلّح مثل «داعش» إن لم تقترن بإنزال قوةٍ برية- من المهاجمين أو من حلفائهم- قويةٍ ومدرَّبة تخوض قتالاً على الأرض. والحال إن الحملة الجوية الأمريكية -الغربية ليست شديدةَ الوطأة ومكثَّفة بحيث تُؤذي، إيذاءً استراتيجياً، تنظيم «داعش» أو تعطِّل قدرتَه على التمدّد والحفاظ على مناطق سيطرته، وأقصى ما تستطيعه (هو) أن تفرض عليه قيوداً محدودة في التحرك بحرّية في المناطق التي لا ترغب الإدارة الأمريكية في سيطرته عليها، أو الاقتراب منها. وإلى ذلك يضاف أن هذه «الحرب الجوية» لم تَدعم من القوات البرّية إلاّ قوىً بعينها دون أخرى (البيشمركة وقوات «الحماية الشعبية» الكردية)، بينما هي تستثني الجيش السوري من التحالف، وتترك للجيش الطائفي العراقي، وردائفه الميليشياوية، التخبّط في أدغال المعارك. هكذا تكشف الحملة عن محدودية إمكاناتها في تغيير مشهد ما يجري منذ سقوط الموصل حتى سقوط تدمر.
وثاني السببين أن الحملة الأمريكية - الغربية تختزل الإرهاب في «داعش»، وتستثني من عملياتها وأهدافها تنظيمات إرهابية عدّة، في سوريا، من بينها «جبهة النصرة» (الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»)، مع العلم ان إدارة أوباما نفسَها وضعتِ «النصرة»، قبل أعوام ثلاثة، على قائمة المنظمات الإرهابية. والأنكى من ذلك أن يصرّح أحد أقطاب الحرب في أمريكا (الجنرال بيترايوس) أن على الولايات المتحدة أن تتعاون مع «المعتدلين» في «جبهة النصرة» لمحاربة «داعش»! إن هذه الانتقائية في التعامل مع الإرهاب- نزولاً عند حلفاء «النصرة» في المنطقة مثل تركيا وغيرها- تطعن في جدّية المسعى الأمريكي إلى «محاربته» حرباً حقيقية ذاتَ أثر.
وعليه، لا مجال لمقارنة هذه «الحرب» الجوية الأمريكية الأطلسية ضدّ «داعش»، مثلاً، بتلك الحرب الجوية الشرسة التي خيضت في أفغانستان، بعد تفجيرات 11 سبتمبر أيلول 2001،ضد «طالبان» وتنظيم «القاعدة». إن مجموع الضربات الجوية التي شُنّت ضدّ «داعش»، منذ عام، لا تعادل في كمّها كما في قوّتها التفجيرية ما شَنَّتْهُ في يومٍ واحد في أفغانستان؛ حيث مئات الغارات الجوية العنيفة كلَّ يوم، وحيث طائرات B52 تلقي عشرات الآلاف من أطنان المواد الشديدة الانفجار على مواقع التنظيمين، فتدمّرها وتدمّر مئات الكهوف في جبال تورا بورا. وفي الموازاة حشدت أمريكا جيشًا برّيًا مدرَّبًا من «تحالف قوات الشمال- (من قوات المجاهدين الأفغان«التي ألحقت بها»طالبان«هزيمةً لتستولي على السلطة في البلاد في منتصف التسعينات). وهو الجيش المحلي الذي أكمل مهمة الحلفاء بعد تدميرهم البنى التحتية العسكرية في أفغانستان.
ما الذي يقف وراء تصميم هذه «الحرب» الجوية ضد «داعش» على النحو الانتقائي والرمزي غير الحاسم، أو غير الكفيل بإلحاق خسارات استراتيجية بكيانها العسكري والسياسي؟
لذلك، فيما نزعم، مبدآن يفسّرانه، أوّلهما أن «داعش» كانت، وما زالت، حاجة أمريكية لتدمير قدرات سوريا وإنهاكها، وتمديد حال الفوضى في العراق وإغراقه في نزاعاته الأهلية. لقد قامت «داعش» - وأخواتها من المنظمات المسلحة في سوريا- بأدوار تخريبية كبرى نيابةً عن الولايات المتحدة ودول الغرب و«إسرائيل». ما قامت به أمريكا وحُلفاؤها في العراق، منذ غزوه واحتلاله في عام 2003، ودفعَت لقاءَه آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وأزمة مالية مروِّعة، تقوم به في سوريا- منذ أربعة أعوام- من خلال وكلاء محليين (باسم الحرية والديمقراطية، ابتداءً، ثم باسم الإسلام تالياً!)، ولكن من دون أن تدفع، هذه المرة، الأكلاف الباهظة التي دفعتها في العراق أو أفغانستان. الحرب، هنا، أبخس ثمنًا من الحروب السابقة، وثمة جيش عرمرم من المقاتلين الجاهزين ل«الجهاد» في سبيل أمريكا! ماذا نسمي الدعم اللوجيستي التركي للمنظمات المسلحة: من التدريب في معسكراتها، إلى الانتقال عبر أراضيها إلى الحدود السورية، إلى تدفّق السلاح منها على سوريا، إلى إيواء قادة الجماعات المسلحة، إلى تدفّق الأموال- الآتية من مصادر أخرى -على تلك الجماعات؟ هل كان ذلك من دون علمٍ تفصيلي من واشنطن؟ ألم يكن مطلوبًا منها ذلك للأهداف التي ذكرنا (تدمير سوريا وتفكيكها)؟ وعلينا أن ندرك أن تلك الحاجة إلى «داعش» في الداخل السوري، اليوم، لم تنته بعد. وحين تنتهي سنشهد، فعلاً، حرباً ضدّها. أما الآن، فكلّ المطلوب أمريكياً (هو) احتواء «داعش» حتى لا تخرج عن مسار الخِطّة المعدّة لها.
وثانيهما أنّ حاجةً رديفًا إلى «داعش» ما زالت قائمة ومستمرة؛ وهي استخدامها فزّاعة لإخافة المحيط العربي لسوريا والعراق وابتزاز دوله. فزّاعة «داعش»، بهذا المعنى استمرار لفزّاعة (الرئيس الراحل) صدّام حسين وما تلاها من فزّاعات أخرى. وهذه، جميعُها، (أي الفزّاعات) جزيلة العوائد السياسية والاقتصادية والمالية على السياسة الأمريكية في البلاد العربية، عامة، وفي بلدان الخليج العربي على نحوٍ خاصّ؛ فهي إذْ تَهُزّ الاستقرار وتَرفع المخَافَة على الأمن الإقليمي، تزيد من معدّل الحاجة إلى دورٍ أمريكي أمني في المنطقة. ليس ثمة، إذاً، من مبرِّرٍ يدفع الإدارة الأمريكية إلى تصفية «داعش»، وحرمان نفسها من هذه الورقة السياسية القابلة للتوظيف لفترةٍ طويلة. لذلك ما كان مستغرَباً أن يتواتر القولُ الأمريكي- بألسنةٍ مختلفة -إن الحرب ضدّ «داعش» ستستمر لسنوات؛ تَوَاضَع الرئيس أوباما في تقدير الزمن فأعلنها سنواتٍ ثلاثًا، فيما لم يتحرّج بعض أركان إدارته وجيشه في الذهاب إلى القول بأضعاف أضعاف هذه المدّة الزمنية!
هكذا يتبدّى أن أزعومة الحرب الأمريكية ضدّ «داعش» ليست أكثر من اسمٍ حركي لتمديد حال الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة العربية، فالذين يصطنعون الأسباب والذرائع للإمساك برقاب العرب، مجتمعاتٍ ودُوَلاً، لا مصلحة لهم في رفع تلك الأسباب والذرائع إلاّ إنِ ارتفعت في سياساتهم الحاجةُ إليها. وعندي أنّ تلك الحاجة باقية ما بقيتِ السياسةُ الأمريكية تجاه الوطن العربي على حالها؛ لا ترى في المنطقة غير مصالحها ومصالح شريكها الصهيوني. ولا شيء يُشبه مَزْعمة الحرب الأمريكية على «داعش» في انفضاحها إلاّ المَزْعمة التركية في الشأن عينه!، ترى، هل ستختلف سيرة روسيا في مواجهة الإرهاب عن سيرة الولايات المتحدة الأمريكية؟